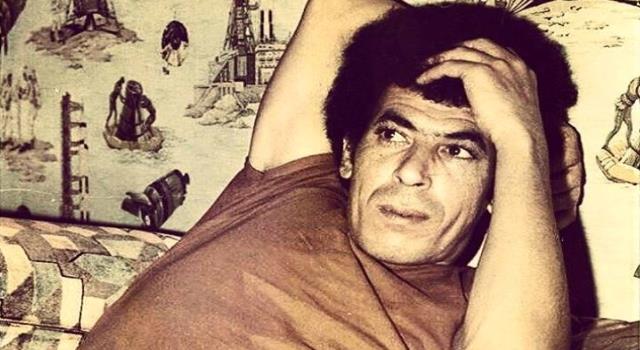لاشك في حجم الارتباك والحيرة التي تنتاب كل متمعن في أفكار وطروحات المفكر الليبي الصادق النيهوم. ومردها صعوبة موضعة هذا المفكر غير المشكوك في تجديده وجديته وسعة تبحره واطلاعه وسفره الطويل في متون الكتب والمدونات واللغات المتصلة بعلوم الأديان وفي مقدمتها الإسلاميات.
فلا تدري إن كنت في مواجهة مجدد حقيقي للدراسة الإسلامية وتطوير المنهج والتصور المجتمعيين باتجاه بلورة رؤية جديدة للوقائع والمستقبل تقطع مع السائد المتحجر المنحط أو أنك أمام مجرد أصولوي لا يستهدف سوى تزويق القديم وإحيائه دون أي مساس أو زحزحة للأصول وما استقر في الذهنية الإسلامية على أنه ثوابت لا تقبل المساءلة أو المساس.
أو بمعنى أدق لنا أن نتساءل هل نحن إزاء مجرد مصلح تقليدي على شاكلة محمد الغزالي يعيد إنتاج شخصية "الشيخ" أو بصدد مفكر مقلب لطبقات التراث العميقة ومفكك لأصولها المعرفية وأدوات إنتاجها للمعنى والخطاب المحجوبة على شاكلة محمد أركون. إجابة أولى عن هذا السؤال نرى بوضوح أن النيهوم يقع في الضفة الثانية تكوينا، حيث تبحر في فقه اللغة المقارن وتتلمذ على أيدي كبار البحاثة الغربيين ونهل من مناهج البحث الحديث ولغاته. بل إنه امتهن تدريسها في جامعات الغرب الحديثة. لكنه، خطابا، يقع في الضفة الأولى، حيث تمتلئ كتاباته بالمواعظ ولغة الدعوى والترغيب الوعظي، وتهيمن اللغة والمصطلحات التراثية الكلاسيكية على مصنفاته.
فالنيهوم، مثلا، يلح في كتابه "إسلام ضد الإسلام" على اعتبار الشورى النظام الصحيح في الإسلام معتبرا إياها فرض عين على كل مسلم وهي النظام الصحيح الذي لا بد من توخيه في المجتمع المسلم داخل مختلف قطاعات الدولة والإدارة. ويؤكد في مرات عدة على مخاطبة الإسلام للمواطنين، وهو مصطلح عرفته الديمقراطيات المعاصرة، في حين أن القرآن يخاطب المؤمنين. وواضح جدا أن المصطلحين ليسا مترادفين. ويؤكد النيهوم استنتاجاته الإطلاقية النهائية في شكل تأكيد دغمائي جازم مستشهدا بآيات قرآنية دون عميق كدح أو تنسيب يفترضهما البحث العلمي العميق. بل إنه لا يتردد في اعتبار ما يطرحه الإسلام الصحيح أو الفهم الصحيح للإسلام المؤسس على الشورى الملزمة للمسلمين باعتبارها فرض عين عليهم يمارسونها بالديمقراطية المباشرة على مستوى القاعدة. ولكي يكون عمليا يرى النيهوم أن الأمر لا يمكنه أن يتحقق إلا في مؤسسة المسجد الداعي إلى رد الاعتبار لها باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسية للممارسة الديمقراطية الشورية المقترحة. نجده هنا يقول بوضوح "أن الإسلام لا يملك وسيلة إدارية لأداء أهم فرائضه (يقصد الشورى) سوى لقاء يوم الجمعة وحده، لا غير". كما إن فهمه لعقيدة أو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا يبدو مسقطا وملتبسا. فهو يعارض بوضوح شكله الفقهي الحنبلي القائم على مؤسسة الحسبة والسلطة العقائدية القهرية، ويحيد به عن مضمونه المعتزلي الكلامي محاولا تعسفا ضمن أركان التأسيس الشوري الديمقراطي الداعي إليه.
لئن كان اعتبار الديمقراطية مرادفا للشورى ليس بجديد عن الفكر السياسي الإسلامي المعاصر إلا أن النيهوم وحده من أعطاه طابعا تقنيا ممارساتيا متماسكا في دعوته لرد الاعتبار لمؤسسة المسجد وتطويرها والحديث بإسهاب عن الوظائف المجتمعية والسياسية، التي تضطلع بها وفق تصوره. ولا بد من التنويه هنا إلى أنه خلافا لمنظري ما يعرف بالإسلام السياسي الذين لا يقدمون أي مقاربة أو مقارنة جديدة ومتماسكة لمبدأ/شعار الشورى وعادة ما يكتفون بالمدح العقيم حول أصالتها وجديتها وأسبقيتها عن الديمقراطية فإن النيهوم وحده من أوجد لها تطبيقا عمليا هو الديمقراطية القاعدية المباشرة وحاضنا اجتماعيا هو مؤسسة المسجد عبر التطوير العملي والوظائفي لما يستطيع القيام به من أدوار.
فالاتفاق أو الاختلاف مع ما يطرحه لا ينزع عنه صفة المجدد هنا والمقدم لحل عملي للمآزق السياسية والأخلاقية والمجتمعية المعششة في الجسد المسلم، والتي كانت السبب في طرح سؤال النهضة العربية المعلوم وتتالي المحاولات والمقاربات المجيبة عنه لاحقا وتصور النيهوم ليس إلا واحدا منها.
لم يحظ مشروع الصادق النيهوم النقدي باهتمام لافت لدى المهتمين بالفكر العربي المعاصر وداخل الأوساط الأكاديمية والبحثية، ربما للصعوبة الواضحة في تصنيفه داخل سلم الخطاب النقدي المعاصر أو لمراوحته بين الأدب والموسوعات والنقد، رغم أن هذه التفصيلة أيضا متصلة بالتصنيف سواء في خانة الأدباء أو المفكرين والمصلحين أو الأكادميين الموسعيين ومدى الاتصال والانفصال بين كل منها. غير أننا نظفر في كتاب المفكر اللبناني على حرب "نقد النص" بدراسة نقدية هامة ومفصلة على هامش كتابه "الإسلام في الأسر"، لعلها تكون أبرز ما كتب عن النيهوم نظرا للقيمة النقدية لكاتبها وانشغاله بكتابات زملائه من الناقدين والمفكرين العرب، لذا يهمنا جدا التوقف عندها.
يفهم حرب أن النيهوم يميز بين الإسلام في صفائه ولحظته التدشينية القصوى وبين التطبيقات الفقهية والسياسية والمجتمعية المحرفة له والآسرة أو المغيبة لهذا الجوهر، حيث يتتافى الواقع مع المثال أي النموذج والتطبيق. ويرى في دعوة النيهوم إلى تحرير الإسلام من أسر الفقهاء وسلاطين الإقطاع نفس الدعوة المنادى بها من طرف الحركات السلفية والدعاة الحاليين والمؤسسة على نموذج أعلى مفترض يتوقف عند عهد الخلافاء الراشدين الأول والثاني ويعمل على إعادة إنتاجه حاضرا وحلا للانحرافات الطويلة اللاحقة. بل يراه أكثر مغالاة ممن ينتقدهم لأنه يقرون في بعض الأحيان بوجود أخطاء وممارسة سلبية في الحقب التاريخية التالية وجب تلافيها وإيجابيات تستحق الشكر والتثمين. بينما يذهب هو إلى نفيها كليا والقطع معها لفائدة إسلام متعال عن الوقائع والملابسات والممارسات التاريخية والإكراهات.
ويرى حرب في ما يذهب إليه النيهوم محاولة لإلغاء حقب تاريخية كاملة وسير رجالات ومجددين وفقهاء أخطأوا وأصابوا وفق إمكانات عصرهم. فمنهم من جلب الفلسفة من اليونان وأعاد تقديمها وتوظيفها للدفاع عن العقيدة ومن جدد أصول الفقه ومارسه وفق نوازل عصره، وهو المبحث الذي يرى حرب أن النيهوم يريد نسفه كلية بسخطه على ممارسات الفقهاء التسلطية الفاسدة في حين أنه منجز مبحث معرفي في حاجة للمقاربة والدراسة والنقد.
الجزء الثاني في دراسة حرب مهم كثيرا بدوره لأنه يتعرض لفهم النيهوم للديمقراطية. فهو يعتبر أن دعوته لاعتبارها صحبة كل المفاهيم الحديثة المجاورة لها مترجمة من الغرب ومسقطة تعسفيا على واقعنا دعوة مخاتلة. لأن النيهوم بدوره صناعة غربية معرفيا ويفتقد للجدة والابتكار ولا يختلف عن باقي الخطابات التي تتلمذ مصدروها في الغرب دون أن يتوقفوا عن ذمه ومدح كل ما أنتجه من قيم. كما يرفض حرب بشدة فكرة جعل الجامع منبرا لتحقيق الشورى والعمل العمومي الخلاق نظرا لأن الجوامع تحتكرها طوائف وفئات تروج لخطاباتها داخل أنصارها وكثيرا ما تهيمن عليها حركات إسلامية متطرفة تدعو من منابرها إلى إلغاء الديمقراطية والكفر بكل مظاهر الحياة المعاصرة. بل حتى في العصر الإسلامي الكلاسيكي لا نظفر بهكذا وظائف للجوامع باستثناء أنها كانت منابر للعلم والتدريس قبل تأسيس الجامعات والمدارس. أما السياسة أو الشورى فتدار خارجه. ويعتبر هذا الحل على قدر من الطرافة والمثالية غير المنسجمة مع الواقع.
ربما بالغ علي حرب في نقده للنيهوم في التركيز على معاداته للغرب وحاول حشره ضمن طائفة من الخطابات السطحية الصدامية المليئة بالحجب والتناقضات على طول الدراسة. بل حتى حديث حرب عن رفض النيهوم للديمقراطية والمنجزات الغربية فيه شيء من الشطط لأن النيهوم ذاته، كما سبق أن ذكرنا، يستعمل الديمقراطية كمرادف للشورى ولا يخلو خطابه من مصطلحات معاصرة ومحاينة. ويعتبر حرب بقدرة النيهوم على التشخيص النافذ والفعال للانحرافات اللبيرالية والإسلاموية المعاصرة وما يعج به مجمل الخطاب السياسي العربي المعاصر من مخاتلات وتلاعب ومغالطات. وبالتالي يفتح لنا الناقد اللبناني البارز بابا مهما للتعريج على ميزة مهمة في مصنفات النيهوم تتعلق بنقده البارع والحاد للممارسات الفقهية والسياسية الإسلاموية الحالية. وهنا بالذات تتجلى راهنية هذا المفكر وجدته وحداثة أدواته ومقارباته، من جهة. ومن جهة، ثانية أهمية ما كتب وآنيته مع هيمنة هذه الحركات الموظفة للمشترك الجمعي العقائدي خدمة لمصالح سلطوية دنيوية.
لقد وظف النيهوم ببراعة واقتدار ترسانته المعرفية وتعمقه في التراث والفللوجية وتحليل الخطاب وغيرها من حقول المعرفة لكشف مختلف أصناف التوظيف والتلاعب الممارسة اليوم على نطاق واسع إسلاميا من طرف هذه الجماعات المحرفة للفهم الجمعي والمهددة بمغالطاتها وممارساتها للوعي والنسيج المجتمعيين، وكأنه كان مستشرفا للحظة. وهذا في حد ذاته مكسب معرفي للخطاب العربي المعاصر يجعل صاحبه إبن هذه اللحظة التاريخية الملغمة ويجعلنا في حاجة ملحة لسجالاته وكتاباته، بغض النظر عن التباس التصنيف وطوباوية أو واقعية المشروع المتكامل، الذي يقترح.