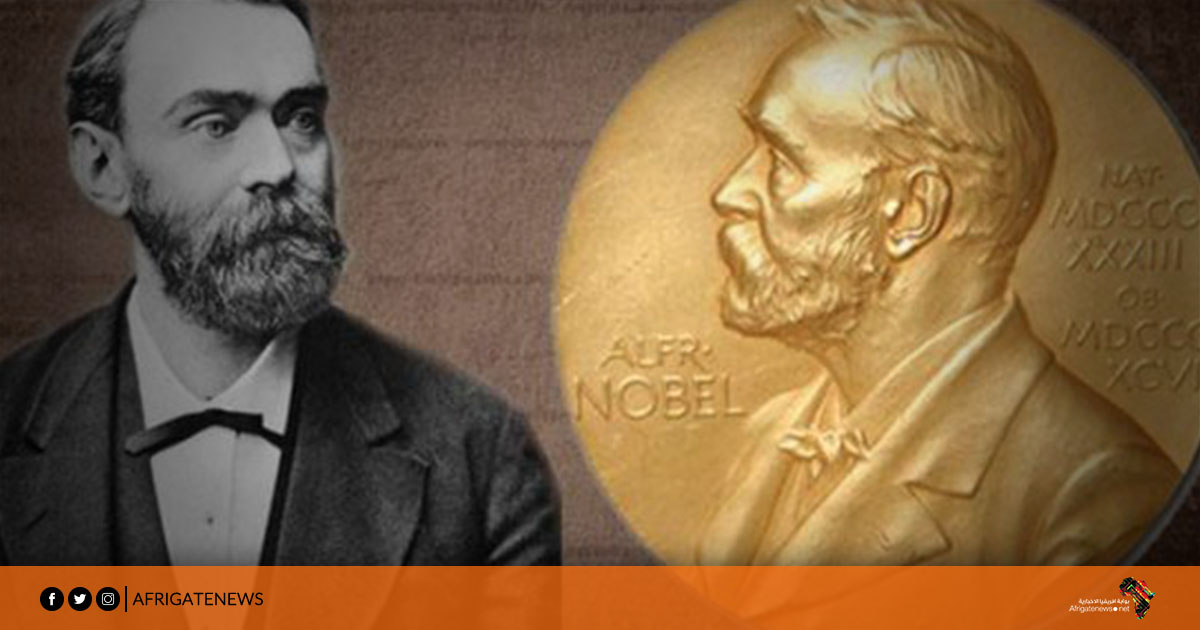على غير ما توقعت الأوساط الثقافية توجهت نوبل لمكان آخر، فلم تمنح لأي من الأسماء التي تم تداولها منذ أسابيع، حيث منحت جائزة نوبل للآداب لعام 2020 للشاعرة الأميركية لويز غليك. لم يكن إعلان نتائج نوبل هذا العام حدثا عاديا، لا لأنها ذهبت إلى غير اتجاه الإبداع الأدبي، بل لان كواليس منحها تختزل الكثير من السياسة والوقائع والتدخلات، على الرغم من القيمة التي تكون للمبدع الذي يستحقها، ولكنها لن تمنح له مهما كانت مكانته مرتفعة ما لم يكن قد نال الحظوة عند من يعمل ويعد القوائم ويبحث في كواليس التاريخ عن شيء يمكن أن يكون قد حدث. هذا العام وبخاصة في زمن كورونا، كان وقع نوبل باردا، باهتا، وعلى ما يبدو بدا ذلك منذ عدة أعوام، إذ تعمد اللجنة المانحة إلى البحث في خبايا كثيرة، وربما تجانب الصواب دائما في منحها، لها ظروفها وقراراتها التي تبقى طي الكتمان لفترة من الزمن، كل خريف ينشغل العالم بمن ستمنح له نوبل للآداب...

وبعفوية نتساءل: ألا يستحق الأدب العربي هذه الجائزة بعد منحها مرة يتيمة لنجيب محفوظ مع الإشارة إلى أنه في كل قطر عربي أدباء يستحقون ما هو أكبر منها...؟!
في نطاقنا العربي المشتكي إلى حد استدرار الإشفاق من تنحية العرب عموماً عن هذه الجائزة العريقة، فمن المناسب أن نلتفت إلى الحقيقة المؤسفة المتمثلة في تخلّف منطقتنا العربية عن الإنتاج المعرفي بأشكاله قاطبة، وخصوصاً في ميادين العلوم الأساسية. وإذا كان لنا أن ندعي أفضليتنا في مجالات الإبداع الأدبي، فثمة ملاحظتان لا بد من تثبيتهما في هذا السياق: تتمثل الأولى في أن ترجمة النص الأدبي إلى لغة أخرى تفقده كثيراً من العناصر التي جعلته نصاً أدبياً في لغته الأم. وعندما يُترجم إلى لغة أخرى كـ (السويدية) عبر لغة وسيطة يتضاعف فقدان العناصر الأدبية بصورة مطّردة مع تكرار اللجوء إلى اللغات الوسيطة. وتتمثّل الثانية في تهافت أنصاف المبدعين العرب، وأرباعهم، وأخماسهم إلى أن تُترجم أعمالهم إلى اللغات الأخرى، وخصوصاً السويدية لغة أعضاء الأكاديمية السويدية مانحة الجائزة، وهو تهافت متعاظم، بوسائل غير نزيهة، لا يستبعد فيها المتهافت مزيداً من تعرية المعرّى فيه، من أجل بلوغ عتبات الترشيح إلى نوبل، حتى لو كان بلوغ العتبة مجرد إشاعة يطلقها هو ذاته عن ذاته، وحتى لو كانت تفوح برائحة غير نظيفة.
دائماً نقول إنها جائزة مسيسة هذا كلام مبالغ فيه، فالجائزة بحد ذاتها ذهبت لكل الأمم لكل مبدع فيها وتعثرت في الوصول إلينا... لماذا؟ فهل عجزت هذه الأمة عن إنتاج أدب يستحق هذه الجائزة؟
يجب أن تكون عندنا الشجاعة لنعترف، أنّ معظم رواياتنا تتناول شريحة إنسانية دون الأخرى وبفوقية، كأن الروائي يبشر برسالة تعنيه شخصياً أكثر مما تعني الناس. غالباً تدخل السياسة في الرواية العربية من زاوية الرأي الواحد دون التفاعل مع الآخر، أياً كان هذا الآخر وفي المقابل نجد روايات عالمية لم تقع في هذا الفخ المميت الذي وقعت فيه الرواية العربية. قد تكون الترجمة سبباً في ذلك، لأن ترجمة رواياتنا كانت تقع على عاتق الكاتب نفسه بما له من اتصالات وعلاقات عامة وأموال يستطيع دفعها للمترجم. إننا أمة تخطط على الخرائط ولا تنفذ، مثل مؤتمرات القمة العربية التي تصيغ قرارات سياسية وأدبية واجتماعية ثم تصبح كل هذه القرارات حبراً على ورق. نحن أمة ثرثرة وكلام (فاضي) لا أمة إنتاج وإبداع، بل الأديب عندنا يستعجل في الكتابة كيفما كانت، لأنه كاتب فقير ويريد أن يعتاش من أدبه، الذي يكون مردوده بضع دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن أهم رواية عربية لا تطبع أكثر من ألفي نسخة، نصفها مرتجع بينما الرواية الأدبية الغربية إن نجحت تطبع مليون نسخة وما فوق. لا تدعم الدولة الكاتب لا تفرغه براتب يضمن حياته وحياة أولاده من أجل أن يبدع ويكتب... هذه في المرحلة الأولى كي ننتج أدباً يستحق الترجمة ويستحق العالمية ويستحق الجائزة الكبيرة، لكن لا الدولة تهتم ولا المؤسسات التجارية ولا البنوك التي لا تحسم من أرباحها واحداً بالمائة من أجل مساعدة كاتب أو شراء كمية كبيرة من رواية كتبها الكاتب بحبر عينيه ودموعه وعلى مدى سنتين أو أكثر ثم لاشيء.
وفوق هذا وذاك، نتساءل دوماً: ألا يوجد عرب يستحقون نوبل؟ لماذا تبتعد هذه الجائزة عن العرب؟ هل العلة في العرب أم في الجائزة؟
يعيد كثيرون ابتعاد العرب عن نوبل وغيرها من الجوائز إلى الانتماء، فمجرد أن يكون المبدع عربياً يجعله فاقداً الأمل في الوصول إلى الجوائز، ونسمع نغمة الدوائر الصهيونية وغيرها، وهذا الأمر فيه شيء من الحقيقة، ولكنه ليس كل الحقيقة، وبخاصة إن تنبهنا إلى أن عدداً لا يستهان من أدباء أميركة اللاتينية حصد هذه الجوائز، فأمر الانتماء على صحته له علاقة بأصحاب الجائزة الذين يتولون أمرها، وله علاقة بالمبدعين العرب الذين غالباً ما يخاطبون أنفسهم على الصعيد الإبداعي، فلا يقدمون حقيقة ما يمثل إضافة وإثراء للإبداع العالمي الذي لا يعرف حدوداً، بينما لا يزال مبدعنا أسير الانتماء وما يجوز وما لا يجوز، لا يزال مبدعنا يتحدث عن التابوهات، وربما وصل إلى انتكاسة جديدة أخرى تعوقه عن الوصول إلى ما وصل إليه المبدعون العرب السابقون.
فالبيئة الحاضنة مؤثر فاعل، وقبل أن نندب حظنا وحظوظ مبدعينا، علينا أن نعالج هذه البيئة، وإعدادها لتصبح حاضنة فاعلة في استيلاد المبدعين، وإذا ما تجاوزنا قامة نجيب محفوظ، وهي قيمة عالية وتستحق أضعاف نوبل، فإن المبدعين العرب الكبار جديرين بهذه الجائزة، ولكنها لم تصل إليهم، العيب كل العيب في البيئة الحاضنة العاجزة عن تسويق مبدعيها في الداخل والخارج، وكل مبدع عربي لقي من الجحود والمحاربة المجتمعية والسلطوية أضعاف ما تتعرض له دول، لذا لم يكن قادراً على تحقيق شرط الإبداع اللازم... وحتى لا يكون الكلام إنشاء نذكر أن الباحث أحمد زويل، حصل على نوبل بصفته الأميركية، وبمركز أبحاثه الأميركي، وبأبحاثه التي روجت لها الدوائر العلمية العالمية، وعند حديثه عن ماضيه في مصر يتبين لنا أنه لو بقي في جامعة المنصورة التي خرج منها فإنه لن يحقق شيئاً، وسيبقى في أحسن الأحوال مجرد أستاذ جيد، وعندما حصل على نوبل حاول تأسيس مراكز أبحاث في مصر والمنطقة، لكن محاولاته ذهبت هباء، وضاعت سنوات من عمره نعتوه فيها بأقسى النعوت... ربما يستطيع تأسيس شيء ما كما يقول الإعلام، ولكنه لن يتمكن من رؤيته متفوقاً وقادراً ومنافساً...!
هل تستطيع هذه البيئة أن تروج لمبدع كان نتاج نفسه؟
لن تستطيع، وستعمل على خنفه ولن تعمل على صنع المبدعين، والإبداع صناعة متكاملة. وللأسف الشديد، تتنازع مبدعينا العرب الصراعات المحلية والإقليمية وتؤثر فيه الإثنيات العديدة في الانتماءات الدينية والطائفية والقومية، وإذا أردنا أن نكون محقين فإن مبدعينا لا يخرجون مهما طال بهم الزمن من هذه الصراعات والإثنيات، ويبقى واحدهم حتى يغادر الدنيا بإرادته وبغير إرادته أسيراً لهذه الصراعات ما يحد من رؤاه ويجعله رهن التناول المباشر، والمناوشات... فالمبدع العربي والباحث لم يكتف بهذا الصراع الذي يجعله قريباً من لوركا وأراغون، ولم يقف عند حدود الصراع الاجتماعي والمجتمعي الذي من الممكن أن يخلق جيلاً جديداً ومجتمعاً مختلفاً يساعد في العملية الإبداعية، بل التفتت إلى صراعات هامشية وضعته فيها البيئة الاجتماعية والسياسية، وانخرط فيها بكليته في الصراعات الداخلية والسلطوية، ومارس مبدعونا في الأزمات نوعاً متردياً من التعاطي والخندقة جعلهم أصغر حتى من المجتمعات المحلية والعربية فما بالنا بالعالمية؟! هذه هي صورة مثقفينا القابعين على كراسيهم فهل يستحقون نوبل؟!
من المؤكد لا، ومن المؤكد أنهم أسهموا في تحييد أنفسهم، وتقدمهم مبدعون آخرون ربما كانت نتاجاتهم متواضعة عدداً وموضوعاً وقيمة، فهل أكون أديباً عالمياً إن لم أكن عالمياً حقاً، وأنشد العالم بشكل حقيقي؟ وهل يستحق ابن العشيرة الذي لم ينفصل حبل سرته عنها أن يكون عالمياً نوبلياً؟
مبدعونا ثابتون في مواقفهم الأولى، وكأن كتاباتهم ودراساتهم ليست سوى جولة سياحية قاموا بها خلال عمرهم المديد للعودة إلى الحلمة الأولى التي رضعوا منها ثباتهم وانتماءهم؟
أناقش هذا الموضوع بمناسبة جائزة نوبل السنوية التي انتهت منذ أيام، وفي القلب غصة لأن الآخر ونحن عملنا في وقت واحد على ضرب الحالة الإبداعية وإنهائها، وعلى ترسيخ الإبداع المتردي، وما تناولته في مقالات أخرى عن استجداء أدباء وأدبيات للجان الجوائز العالمية في الموضوعات المجتمعية والجنسية يسهم إسهاماً كبيراً في ضرب الحالة الإبداعية وإعادتها إلى الوراء سنوات وسنوات.
يبدو أن الجائزة ليست على الدوام انحيازاً، وإنما هناك شروط يجب أن تتوفر، ونحن العرب لا نزال نعيش في دائرة ضيقة، ونظن أن العالم يتوجه إلينا بأنظاره، وأن ما نقوم به محط اهتمام... لذا لم يستطع أي من مبدعينا الوصول إلى نوبل، وكذا أمر مبدعينا الذين كتبوا للتقرّب من الآخر وجوائزه، فخسروا أرضيتهم، ولم يحظوا برضا الآخر! وأسمح لنفسي أن أكون ناقداً وواخزاً للذات، فهل يعقل لمبدع يطبع في أحسن الأحوال ألف نسخة من كتابه بالعربية، ويبقى سنوات دون أن يجد من يقرؤه، وربما لا يسوّق إلا في إطار قطري، ولا يترجم ولا يكتب عنه ليصل إلى نوبل؟! أحياناً لا تسمع الزوجة بما قدمه السيد زوجها المبدع، فكيف سيصل إلى العالمية ونوبل؟! وأذهب أبعد من ذلك، لأقول: إن القارئ العربي يقرأ ويتابع، وليس صحيحاً أنه لا يقرأ، ولكن يقرأ ما يستحق، فهل يكتب مبدعونا ما يستحق القراءة؟! إن كان لا يستحق القراءة من أبناء العربية، فهو من باب أولى لا يستحق القراءة من الآخر!
خلاصة الكلام: يقولون عنا إننا أمة لا تقرأ... وإن ثلث الأمة العربية من الأميين، وإن النخبة المثقفة لا تتجاوز واحد بالمائة، وهذا عجز كبير في أمة كانت ذات يوم رسالة حضارة وانجازات، إلى أن وصلنا لأن نكون في ذيل الأمم الأخرى، لا في مقدمها هذا العجز على مختلف المستويات لا ينتج أدباً عالمياً ولا روايات إنسانية تذكر العالم أننا أمة مازالت تعيش.
مصطفى قطبي/ كاتب صحفي من المغرب.